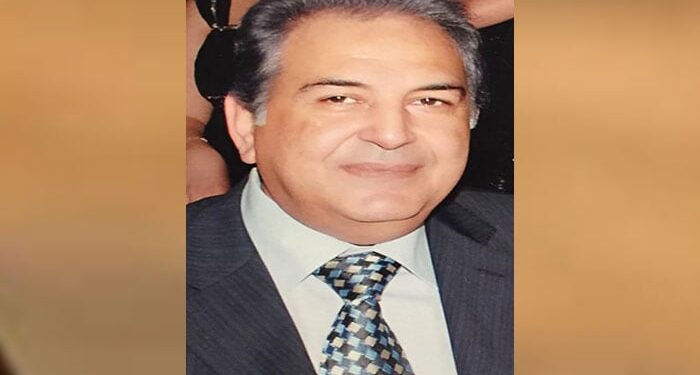في الوقت الذي تواجه فيه الدولة المصرية تحديات جسيمة على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية، يثور التساؤل مجددًا حول جدوى وجود مجلس الشيوخ “سابقًا مجلس الشورى”، ومدى فعاليته في دعم الحياة السياسية والبرلمانية، وما إذا كان حقق منذ إنشائه مردودًا يُبرّر ما يُنفق عليه من موارد الدولة.
صحيح أن وجود مجلس الشيوخ له سند دستوري واضح في التعديلات الأخيرة لدستور 2019، والتي أعادت إحياءه بعد أن أُلغي مجلس الشورى بموجب دستور 2014، إلا أن الواقع السياسي والتشريعي يُظهر أن أداء المجلس ظل هامشيًا، استشاريًا، قليل الأثر، دون أن يترك بصمة تشريعية أو رقابية تذكر.
فعلى مدار العقود السابقة، سواء في شكله القديم (الشورى) أو الحديث (الشيوخ)، لم يكن للمجلس دورٌ محوري في مواجهة الأزمات أو المساهمة الفعالة في بلورة قوانين مفصلية للدولة، بل بقي أقرب إلى “هيئة شكلية” تكميلية، دون فاعلية حقيقية، بينما ظل القرار التشريعي والرقابي في يد مجلس النواب وحده.
من أخطر ما يمكن أن تقع فيه الدول هو ترك صناعة القرار المصيري في يد فرد واحد، دون آليات مؤسسية تضمن التقييم الجماعي.
وقد كانت تجربة قرار الرئيس جمال عبد الناصر بخوض حرب اليمن دون الرجوع إلى دوائر صنع القرار العسكري والاستراتيجي أحد أبرز الأمثلة على هذا الخلل، وما جرّه من استنزاف عسكري واقتصادي، دفعنا ثمنه لاحقًا في نكسة يونيو 1967.
من هنا، فإن وجود مجالس استشارية كفؤة ومستقلة مثل مجلس الشيوخ كان يجب أن يكون صمام أمان، لكنه لم يؤدِ هذا الدور بسبب ضعف استقلاليته وافتقاره للسلطة الفعلية والتأثير الملزم.
ومن مظاهر الاختلال الأخطر التي تستدعي التوقف الجاد، ما بات يُعرف باسم “قوائم الدفع المسبق”.
فمن الملاحظ أن مرشحي الأحزاب الكبرى الراغبين في دخول مجلسي النواب أو الشيوخ يُلزمون بدفع مبالغ مالية ضخمة للحزب، تصل أحيانًا إلى ملايين الجنيهات، سواء تحت مسمى “تبرعات” أو “دعم للحملة”، في مقابل ضمّهم إلى القوائم الانتخابية المغلقة.
خطورة هذا النمط:
• تحويل التمثيل النيابي إلى استثمار خاص بدلًا من كونه واجبًا وطنيًا.
• تفريغ المجلس من الكفاءات الجادة التي لا تملك المال لكنها تملك الرؤية.
• خلق نواب غير معنيين بخدمة الشعب، بل باسترداد ما دفعوه، ولو عبر شبكات المصالح والصفقات.
• تقوية الولاء للحزب على حساب الوطن والمواطن.
هذا السلوك المدمر يهدم جوهر الديمقراطية من الداخل، ويؤسس لمسرحية تمثيلية لا تمثيلًا حقيقيًا.
هل نحن بحاجة فعلًا إلى مجلس الشيوخ؟
لقد ظل غياب مجلس الشورى بين 2013 و2019 دون أثر يُذكر على الحياة التشريعية أو السياسية، ولم يشعر الشارع بوجود فراغ مؤسسي عند غيابه، ما يُلقي بظلال الشك حول مدى ضرورتِه في صورته الحالية.
ومع عودته في شكل “مجلس الشيوخ”، لم تتغير الصورة كثيرًا:
• لا مبادرات تشريعية مؤثرة.
• لا مواقف حاسمة تجاه قضايا مفصلية.
• لا رقابة نوعية ولا تحليلات قومية تُستنار بها الدولة.
بل إن الكثير من المواطنين لا يعرفون أسماء أعضائه أو طبيعة عمله، وكأن المجلس قائم بالاسم فقط، دون ظل يُشاهد أو صوت يُسمع.
إلى أين نذهب من هنا؟
إذا أردنا لمجلس الشيوخ أن يكون إضافة حقيقية للدولة المصرية، فلابد من:
1. منحه صلاحيات حقيقية، لا أن يُكتفى بدوره الاستشاري الشكلي.
2. ضمان استقلاليته عن السلطة التنفيذية والحزبية.
3. إخضاع آلية الترشح لقواعد الشفافية وتكافؤ الفرص، لا للبيع والشراء.
4. تعيين شخصيات ذات ثقل وطني وفكري، وليس من أصحاب الولاءات الضيقة.
5. وضع معايير للقياس والتقييم لأداء المجلس وأعضائه، كي يُحاسب من يقصّر، ويُكرم من يُخلص.
بإيجاز..إن الحفاظ على المؤسسات لا يكون بتقديسها، بل بتفعيلها.
وإن صيانة هيبة الدولة لا تكون بكثرة مجالسها، بل بنجاعة مؤسساتها.
وإذا كان المواطن العادي يدفع ثمن الفشل السياسي والاقتصادي، فإن من واجبنا أن نعيد تقييم الكيانات التي تُمول من ماله، ولا تُقدم له إلا الوعود أو الصمت.