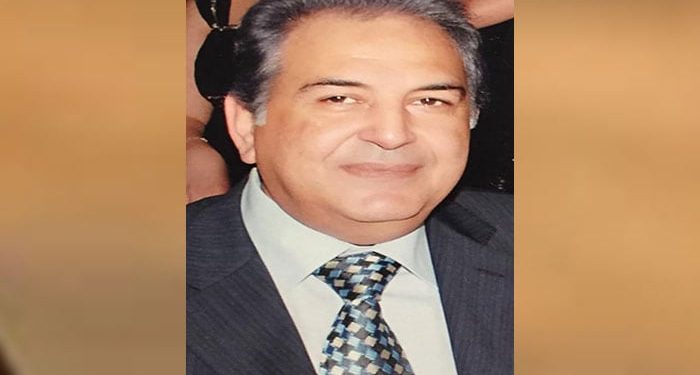من يتأمل المشهد السوري اليوم يدرك أن ما جرى لم يكن وليد اللحظة ولا مجرد تحوّل داخلي، بل هو نتيجة صفقة كبرى بين القوى الدولية، أعادت رسم خريطة النفوذ في سوريا، وجعلت انتقال السلطة إلى جماعة الشرع يمر كما لو أنه نزهة سياسية لا معركة مصيرية. والسؤال الذي يتردد على ألسنة كثيرين: لماذا لم تتحرك القواعد الروسية في حميميم وطرطوس دفاعًا عن النظام الذي طالما وقفت خلفه، وكأن موسكو تركت المشهد يتغير أمام أعينها دون مقاومة؟
الحقيقة أن روسيا، منذ تدخلها عام 2015، لم تكن مدفوعة بحلم إعادة بناء سوريا كدولة قوية، بل برغبة في تثبيت أقدامها في المتوسط وضمان قواعدها العسكرية ومصالحها الاقتصادية في الطاقة والفوسفات. ومع اشتعال حرب أوكرانيا واستنزاف روسيا عسكريًا واقتصاديًا، تراجعت أولوية سوريا في حسابات الكرملين، وتحولت من ساحة نفوذ مباشر إلى ورقة مساومة تستخدمها موسكو مع واشنطن وأنقرة وطهران. لذلك بدا غيابها عن المواجهة الأخيرة أقرب إلى اختيار محسوب منه إلى ضعف مفاجئ.
من ناحية أخرى، لا يمكن إغفال حقيقة أن سوريا اليوم ليست دولة واحدة بالمعنى العملي. فالشرق تحت النفوذ الأمريكي – الكردي، والشمال تتحكم فيه تركيا، والجنوب يخضع لمعادلات أمنية تفرضها إسرائيل، بينما يبقى الساحل وبعض الداخل تحت عين موسكو وطهران. هذه الخارطة لا تُترجم بعد إلى تقسيم رسمي معترف به، لكنها تعكس بوضوح “تقسيم الأمر الواقع”، حيث لكل قوة حساباتها ومصالحها التي تتقدم على سيادة الدولة ووحدتها.
المؤشرات القوية تقول إن ثمة تفاهم غير معلن بين روسيا وأمريكا، برعاية إسرائيلية ضمنية، يقضي بتقاسم النفوذ وتثبيت خطوط السيطرة، مقابل ضمانات متبادلة. فواشنطن لم تعترض على بقاء القواعد الروسية في الساحل، وموسكو من جانبها لم تمانع صعود جماعة الشرع ما دام ذلك لا يمس وجودها العسكري. أما إسرائيل، فقد حصلت على ما تريده: وعود باتفاق أمني يضمن منطقة عازلة في الجنوب ونزع السلاح على حدودها. وتركيا في المقابل أحكمت قبضتها على الشمال لتأمين جبهتها ضد الأكراد.
بهذا المعنى، فإن غياب التصدي الروسي لما حدث لا يعكس انسحابًا كاملاً بقدر ما يكشف عن “موافقة ضمنية” على ترتيب جديد، يوزّع النفوذ بين القوى الكبرى، ويبقي سوريا في حالة تجزئة طويلة الأمد. قد لا نرى تقسيمًا رسميًا تُرسم فيه حدود جديدة، لكننا نعيش فعلًا مشهد التقسيم الواقعي، حيث تتحول البلاد إلى رقع جغرافية تدار كل منها بوصاية مختلفة.
لقد انتهى زمن “سوريا القديمة” التي كانت دولة مركزية قوية، وما يجري اليوم يؤكد أن ولادة “سوريا جديدة” ستكون على أنقاضها، ولكن بأي هوية، وتحت أي وصاية، وبأي ثمن… هذا هو السؤال الذي سيظل مفتوحًا إلى أن يحسمه المستقبل.