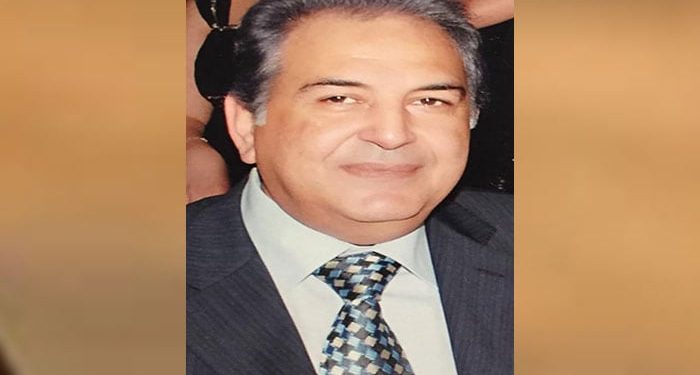لم يكن أحد يتخيل أن تتحول السعودية، أرض الرسالة ومهد الدعوة وموطن الحرمين الشريفين، إلى ساحة تُرفع فيها أصوات الموسيقى وتُقام فيها مهرجانات الرقص والعروض الصاخبة بهذا الشكل. ما يجري هناك اليوم لا يمكن اعتباره مجرد انفتاح اجتماعي عابر أو تطوير اقتصادي بريء، بل هو تحوّل بنيوي في هوية المجتمع نفسه، وفي الصورة الذهنية التي كوّنها العالم عن المملكة منذ نشأتها.
السعودية كانت تُعرف بكونها آخر حصون الوقار في العالم العربي والإسلامي، تجمع بين ثروة الأرض وقدسية السماء، وكانت هويتها المحافظة مصدر قوتها الناعمة لا عبئًا عليها. وحين قررت أن تدخل هذا المسار المثير للجدل، لم يكن القرار نابعًا فقط من رغبة داخلية في التغيير، بل من واقع عالمي ضاغط صُمم بعناية كي يدفعها إلى هذا الاتجاه.
في عالم اليوم، لا تُفرض القرارات على الدول كما كان يحدث في زمن الاحتلال، بل تُفرض بأسلوب ناعم ومغلف بشعارات براقة مثل “التطوير” و“الانفتاح” و“جودة الحياة”. لم تتلقَّ السعودية أمرًا صريحًا من الخارج، لكنها وُضعت داخل منظومة تجعل استمرارها في موقعها العالمي مرهونًا بتغيير صورتها التقليدية. فالاقتصاد العالمي، والإعلام الغربي، ومراكز الاستشارات الأجنبية، جميعها صاغت مفهومًا أحاديًا للتقدم، يربط التمدن بالتحرر الاجتماعي والانفلات من التقاليد. وهكذا وُجدت القيادة السعودية أمام خيارين كلاهما صعب: إما أن تحافظ على هويتها وتُتَّهم بالجمود، أو تواكب “العصر” بما يعنيه من مظاهر صاخبة، فتخسر جزءًا من روحها وتاريخها.
الاختيار الذي اتخذته الدولة لم يكن قرارًا سياديًا خالصًا بقدر ما كان استجابة لضغط الواقع الدولي وشروطه غير المعلنة. إنه نوع من الفرض الناعم الذي يجعل الدولة تظن أنها تختار بحرية، بينما هي تسير في الاتجاه الذي رُسم لها مسبقًا. الغرب لم يطلب من السعودية علنًا أن تفتح مسارحها وتُقيم حفلاتها، لكنه فتح أمامها أبواب الاستثمار والسياحة المشروطة بصورة جديدة أكثر قبولًا في نظره، وأوحى أن “التطور” لن يُصدَّق إلا إذا تجلى في المظهر والسلوك واللباس، لا في الصناعة والعلم والإدارة.
وهنا وقع الخلط الخطير بين تحديث الاقتصاد وتشويه الهوية. فبدل أن تُوجَّه الجهود إلى تنمية الصناعة وتطوير التعليم ومحاربة الفساد وإعادة توزيع الثروة، اتجهت الأنظار إلى مشروعات الترفيه باعتبارها واجهة التغيير. فجأة صار الرقص والغناء عنوانًا للتقدم، وكأن الأمم تُقاس بقدر ما تكسر من الحياء لا بقدر ما تُنتج من المعرفة.
لكن هل كانت التقاليد السعودية أصلًا عائقًا أمام التطوير؟ الجواب قطعًا لا. فالمملكة أنشأت مدنًا صناعية وجامعات ومطارات حديثة وهي في ذروة تمسكها بعاداتها واحتشامها. لم يكن الدين هو الذي يعطل التنمية، بل البيروقراطية والفساد وضعف الكفاءة. والآن، بعد أن أُزيحت القيود الاجتماعية، لم نشهد انفجارًا إنتاجيًا ولا ثورة علمية، بل ضجيجًا استهلاكيًا يستنزف الأموال ولا يضيف قيمة حقيقية.
من الناحية الاقتصادية البحتة، لا يمكن لأي خبير أن يزعم أن الحفلات والمواسم الترفيهية قادرة على بناء اقتصاد متين. العائد المالي المباشر محدود وموسمي، بينما الكلفة ضخمة والاستفادة الفعلية تصب في جيوب شركات أجنبية وفنانين وافدين. أما المكاسب الاجتماعية فهي شبه منعدمة، لأن هذه الأنشطة تُحدث شرخًا في الوجدان الجمعي، وتُفقد الأجيال الشابة إحساسها بخصوصية وطنها وقدسية أرضها. لقد تحولت “رؤية 2030” في بعض جوانبها إلى مشروع انبهار جماعي، يلمع من الخارج ويهتز من الداخل.
ولمن يظن أن هذه المهرجانات تحقق عوائد مالية تُسهم في تنمية الموارد، فليعلم أن الأرقام الفعلية تكشف العكس تمامًا. العائدات التي تُعلن عنها الجهات المنظمة لا تمثل إلا نسبة ضئيلة جدًا مما يُصرف فعليًا على تنظيم تلك الفعاليات، من استقدام فنّانين عالميين بعقود خيالية، إلى تجهيزات وإعلانات واستضافات تكلّف مئات الملايين من الدولارات سنويًا. الميزانيات المهدَرة في هذه المواسم، لو وُجهت إلى الصناعة الوطنية أو تطوير التعليم أو دعم المشروعات الصغيرة، لأحدثت فارقًا حقيقيًا في حياة الناس. أما الادعاء بأنها “تنمية للموارد” فليس إلا تبريرًا شكليًا يغطي هدرًا واسعًا للمال العام في أنشطة لا مردود لها سوى إبهار إعلامي زائف. إن الدولة والشعب أولى بتلك المليارات من إنفاقها على حفلات عابرة لا تترك وراءها إلا صدى الضجيج وشيئًا من التنافر القيمي والاجتماعي.
والأدهى أن هذا التوجه يُسوَّق للعالم على أنه دليل تحضر، بينما هو في جوهره نزيف هوية لا أكثر. الغرب يصفق لهذا التحول لأنه يعلم أن تفكيك رمزية السعودية المحافظة يعني إضعاف مركز الثقل الأخلاقي في العالم الإسلامي. فحين تُصبح أرض الحرمين مقبولة في ثقافة الجسد والإغراء، تُرسَل رسالة ضمنية إلى مليار ونصف مسلم أن الدين نفسه تراجع عن حيائه. تلك هي المعركة الحقيقية التي تُدار الآن لا بالسلاح، بل بالصورة والنموذج.
كان في مقدور المملكة أن تسلك طريقًا مختلفًا تمامًا، فالسياحة الدينية وحدها كافية لبناء اقتصاد متنوع ومستدام دون أن تمسّ قدسية الأرض أو تُجرح القيم. ملايين المسلمين يتجهون إلى مكة والمدينة كل عام، وكان تطوير هذا القطاع بالعلم والتنظيم كفيلاً بتحقيق عائد يفوق أضعاف ما تحققه كل المهرجانات مجتمعة. فلماذا تُزاحم قدسية المكان بسياحة صاخبة لا تشبهه؟ ولماذا تُصر دولةٌ تمتلك الحرمين على أن تُنافس مدن اللهو بدل أن تبقى في موقع الريادة الروحية؟
الحقيقة أن ما يجري لا علاقة له بالتطوير بمعناه الحقيقي. التطوير لا يُقاس بعدد الحفلات ولا بنوع الملابس ولا بمستوى الضجيج. التطوير هو بناء الإنسان المنتج الواعي، لا المستهلك المنبهر. هو تحرير العقول من الجهل، لا تحرير الأجساد من الحياء. هو فتح المصانع والمراكز البحثية لا فتح المسارح في أرضٍ تقدّس السكينة والخشوع.
ومن الخطأ أن يُقال إن من يعارض هذا المسار متشدد أو عدو للتقدم. النقد الصادق ليس عداوة، بل حرص على ألا تفقد الأمة آخر ما يميزها. السعودية لا تحتاج أن تشبه أحدًا، فالعالم كله يحترمها حين تكون مختلفة، حين تكون صوتًا للحكمة لا صدى للضوضاء.
التطور لا يتنافى مع الدين ولا مع الاحتشام. لقد بلغت أممٌ القمة وهي أكثر منا تمسكًا بقيمها، ولم نرَ في مصانعها راقصاتٍ ولا في مؤتمراتها حفلاتٍ مفتوحة. النهضة تبدأ من الانضباط والعمل والإنتاج، لا من الإغراء والتقليد. وإذا كان البعض يرى في هذه المهرجانات وسيلة لتحسين الصورة، فالحقيقة أنها تُسيء إلى جوهر الصورة أكثر مما تُجمّلها.
إن ما يحدث اليوم في السعودية لا يمثل صراعًا بين الدين والتقدم كما يُروَّج، بل صراعًا بين هوية أصيلة وضغوطٍ عالمية تُراد لها أن تذوب. والنتيجة حتى الآن تُثبت أن العوائد المادية مؤقتة، أما الآثار الاجتماعية والأخلاقية فدائمة وخطيرة. السعودية لم تُجبر بالسلاح، لكنها أُخذت بالانبهار والإيحاء، وهذا أخطر أنواع الفرض لأنه يُخدر الوعي قبل أن يهدمه.
في النهاية، ليست الحداثة أن نرقص أكثر، بل أن نعمل أفضل. وليست الحرية أن نخلع الحياء، بل أن نملك إرادة الاختيار الواعي. ومن يظن أن الرقيّ يعني التنازل عن الوقار، فقد خسر الاثنين معًا. السعودية لا تحتاج إلى أن تُثبت للعالم أنها عصرية؛ يكفي أن تُثبت لنفسها أنها ما زالت وفية لرسالتها التي انطلقت من مكة، لا من المسارح.